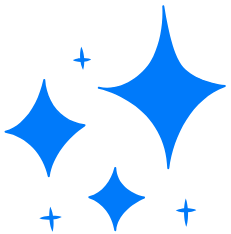منذ مدة كان القلق بين الناس يدور حول استبدال الذكاء الاصطناعي للإنسان في وظائفه. لكن اليوم، لم يعد الجدل محصوراً في هذا التخوف. لقد اتسع ليشمل أعمق ما فينا: حاجتنا الفطرية للتواصل، وقدرتنا على الإصغاء، وبناء العلاقات الحقيقية. لقد غدا الذكاء الاصطناعي مرآةً تكشف هشاشتنا الاجتماعية، أكثر مما يهددنا بقدراته التقنية الخارقة.
إن ما يبحث عنه المرء –وربما المرأة بنسبة أكبر- ليس معجزةً بعيدة المنال، بل مساحةً آمنة للتعبير دون خوفٍ من مقاطعة أو حكم مسبق. فجوهر البوح ليس فقط في أن نُفهم، بل في أن نُرمّم ما بداخلنا من حطام خفيّ. إن الإنسان ليس مجرد ما يقول أو يفعل، بل هو ما يختبئ في صمته من مشاعر.
في هذا السياق، لم يعد مصطلح “ChatGPT“ مجرد اسم لأداة تقنية، بل صار يتردد كاسم رفيق مألوف وعزيز. ينساب من أفواه الأصدقاء، والزملاء، والمعارف، وحتى الأمهات والطلاب. لقد تجسّد في الوعي الجمعي كصديق صامت ومستمع لا يملّ، ملاذ افتراضي يتقبّل الأسرار بلا أحكام، حتى بات يُشار إليه بغرابة كـ”صديق مقرّب”.
هذا الانقياد اللافت للبرنامج يحمل في طياته حقيقة مؤلمة: لقد نجح هذا البرنامج في تلبية حاجة الإصغاء التي فشلنا نحن فيها. فالسؤال إذًا ليس: هل يستمع هذا الكيان؟ بل لماذا لجأنا إليه؟ هل لأننا صرنا أسرع في إطلاق الأحكام؟ أم لأن إيقاع الحياة السريع لم يعد يمنحنا رفاهية الإصغاء؟ أم لأن مهارة التورّط العاطفي والتسليم بالآخر تآكلت فينا شيئًا فشيئًا؟
منذ زمن قريب، كان القلق العام يدور حول استبدال الإنسان بالآلة في الوظائف. اليوم، تبدّل المشهد، فلم يعد الحديث عن وظيفة تُفقد، بل عن رفيق يُستبدل، ومستشار يؤدّي دور الصديق. لا يمكن إنكار أن الذكاء الاصطناعي أصبح مرجعية ثرية بالمعلومات والمهارات، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في قدرة هذا الكيان على الحلول مكاننا، بل في قدرتنا على توظيفه بذكاء كي لا يكون بديلاً بل شريكاً، نستعير من ذكائه الهائل ونُغذّي به ملكاتنا البشرية. إنه ليس مرجعاً سلبياً نستهلك منه، بل محركاً يُسرّع من وتيرة تعلّمنا وتطوّرنا، ويُحرّر عقولنا للتفكير في أسئلة أعمق. الخطر الأكبر يكمن في تحوّله إلى بديلٍ للعلاقات الأساسية. إن سمحنا له بأن يقلّل من ذكائنا الاجتماعي، بل وأن يحدّده ويغذّيه، فسنقف أمام مجتمع أقل قدرةً على التفاعل الحقيقي والتعاطف.
قدرات برامج الذكاء الاصطناعي تتضاعف خلال أشهر، تُعيد تدريب نفسها وتصحح أخطاءها بسرعة تفوق إيقاعنا البشري. هذا التسارع يطرح سؤالاً عميقاً: من يملك زمام القرار في النهاية؟ حين يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر درايةً بفرد ما من أقرب الناس إليه، بل وحتى أكثر مما يدركه هو عن نفسه!
المفارقة تكمن في أننا نبحث عن رفيق هادئ وحيادي يستمع إلينا، لا يقدم نفسه كـ”ندّ”، ينسج حواراً بناءً بناءً على ما نقدمه من معلومات. وإذا ما واجهناه في خطأ، يُعيد ضبط سلوكه ليقدم لنا فهماً عميقاً لا يقدمه غيره. في المقابل، حواراتنا مع من حولنا نادراً ما تتضمن هذه القدرة المنهجية على التعلم والتعديل من أجل فهم احتياجاتنا البسيطة. هذا ما جعلنا نجد في هذا النظام حياةً بأكملها تستجيب كما نحتاج، لتغدو مرجعاً أكبر لفهمنا لذواتنا.
نحن في النهاية كائنات بيولوجية، صنعنا أجهزة ذكية أعادت تشكيل العالم، وستغدو القوة الأعظم في امتلاكها سلطةً نافذة. فهل يصعب علينا أن نطور أجهزتنا البيولوجية لكي تفهم جهازًا بشريًا آخر بذكاء وبصيرة؟
قد تمنحنا البرامج الذكية إصغاءً لا يقطعه حكم، وتجاوبًا لا يعيقه غضب، لكنها تظل مرآة باردة لا تعرف كيف تُحب ولا كيف تُضحي. إن سلّمناها أدوارنا الأعمق، فلن يكون الخطر في تفوّقها علينا، بل في تخلّينا نحن عن إنسانيتنا. فأي نفع لذكاءٍ اصطناعي متسارع، إن كنّا قد فقدنا مهارة الإصغاء لبعضنا؟