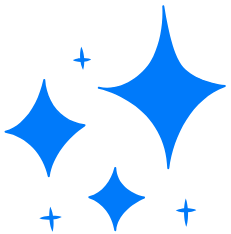من نافذة بعيدة: الكتابة من الحافة
أكتب هذه السطور من بويرتو إيغوازو، في مقاطعة ميسيونيس، حيث تقف الأرجنتين عند تخوم الطبيعة العظمى. هنا، لا تبدو الكتابة مجرّد تسجيل لأحداث رحلة، بل محاولة للإمساك بخيط خفيّ يصل الجغرافيا بالذاكرة، والمكان باللغة، والسفر بالهوية. ليست هذه اليوميات محاولة لاستخلاص حكمٍ جاهزة، ولا سجلًا سياحيًا للأمكنة، بل تمرينٌ على الإصغاء: للثقافة، وللذاكرة الإنسانية، وللنداء الخفي الذي يجعل بلدًا بعيدًا يبدو، على نحو غامض، قريبًا.
وجدت نفسي أعود إلى سؤال بسيط في ظاهره، معقّد في جوهره: لماذا قطعتُ هذا البعد كلّه، وحيدًا، من المغرب إلى أقصى الجنوب الأمريكي؟
الأرجنتين بلد شاسع، يكاد يكون قارة داخل قارة. بوينس آيرس، البامباس، باتاغونيا، أوشوايا… أسماء لا تُقال، بل تُتذوّق. أماكن تسكن المخيّلة قبل أن تطأها الأقدام. ومع ذلك، لم يكن سحـر الطبيعة وحده ما قادني إلى هنا.
لم آتِ إلى هنا بحثًا عن بطاقة بريدية جميلة، بل بدافع افتتان قديم بثقافة أمريكا الجنوبية، وبالأرجنتين تحديدًا، باعتبارها فضاءً كثيفًا بالمعنى. جئتُ مدفوعًا بالكومبيا والتانغو، بهذه الموسيقى التي تشبه اعترافًا جسديًا بالحزن، وبهذا الرقص الذي وُلد من المنفى والحنين والهوية الممزقة. جئتُ لأنني قرأت بورخيس، وشعرت أن المتاهة ليست فكرة فلسفية فقط، بل مدينة كاملة. لأنني توقفت طويلًا عند كورثاثار، وهو يجعل من التفاصيل العابرة مفاتيح لوجودٍ آخر. ولأن ساباتو أقنعني أن الأدب يمكن أن يكون مواجهةً مباشرة مع العتمة.
ثم كان تشي غيفارا حاضرًا، لا بوصفه أيقونة سياسية فحسب، بل كرحّالة، كإنسان غادر البيت ليعرف نفسه والعالم. دراجته النارية الأولى، وعبوره هذه القارة، جعلا السفر نفسه فعل تفكير، لا مجرد انتقال.
الغربة اللغوية: حب الإسبانية دون امتلاكها
أحب الثقافة الإسبانية، وأشعر بقربٍ عميق من عالمها، لكنني لا أتقن الإسبانية. أسمعها أكثر مما أتكلمها، أفهم نبرتها قبل قواعدها، وألتقط روحها حتى حين تعجز الكلمات.
أنا مغربي، لا تربطني بالأرجنتين روابط دم أو عائلة. لا جدّ لي هاجر، ولا عمّ ينتظرني. علاقتي بهذا المكان ثقافية محضة، وربما لهذا السبب هي أكثر صدقًا: علاقة اختيار، لا وراثة. اللغة هنا ليست بيتًا جاهزًا، بل نافذة أطلّ منها، أتعلم، وأخطئ، وأصغي.
كانت الرحلة ثمرة قرار بسيط، مدعوم بإمكانية عملية: نقاط سفر متراكمة مع شركة إيبيريا، تمنحني حرية الوجهة. اخترت الأرجنتين لأن الاسم وحده كان كافيًا لإثارة السؤال.
في الأشهر السابقة للسفر، تابعت السياسة الأرجنتينية من بعيد، ورافق ذلك فوز خافيير ميلي في الانتخابات الرئاسية. كنت أعلم أنني أصل إلى بلدٍ يعيش تحوّلًا حادًا، وأن المزاج العام متوتّر، متسائل، وربما منقسم. وهذا، في حد ذاته، جزء من معنى الرحلة.
عبور الأطلسي: عزلة السماء
رحلة IB 4658، في العاشر من يوليو، كانت هادئة في معظمها. بعض الاضطرابات الخفيفة، كأن الطائرة تذكّرني بأن العبور ليس بلا مقاومة. في الساعات الطويلة، كتبتُ وتأملتُ، وراقبتُ كيف يتحول الزمن في الجو إلى مادة لينة.
وصلتُ إلى بوينس آيرس ليلًا. الشتاء كان حاضرًا بقسوته، والبرد حاد. بعد خطأ صغير في صرف بعض الدولارات، خرجتُ من المطار لأجد أوسوالدو في انتظاري، يحمل لافتة وابتسامة صامتة.
أوسوالدو رجل أرجنتيني من أصول إسبانية، مزدوج الجنسية، وله ابنة تعيش في برشلونة. يملك مكان إقامة يُدعى لا بوليتا، وهو من تكفّل بنقلي من المطار مقابل عشرة دولارات فقط.
الحديث معه كان درسًا في الإصغاء. يتكلم ببطء، بلهجة أرجنتينية واضحة وانجليزية متكسرة، لكنه ينتقي مفرداته بعناية. لم يكن حوارنا لغويًا بقدر ما كان إنسانيًا وسياسيًا. كان مطلعًا على السياسة الأوروبية، وناقشنا الأحداث الأخيرة بشغف.
أنا، حين أسافر، أفضّل الإصغاء. أعرف موقفي، لكنني أتعلم أكثر حين أترك للآخرين أن يكشفوا عالمهم. من حديثه، استنتجت أنه ناخب يميني معتدل، مؤيد لميلي رغم تحفظه على أساليبه. السياسة هنا ليست تنظيرًا، بل انعكاسًا لحياة يومية ثقيلة.
الأحياء القريبة من مطار إيزيزا بدت لي متواضعة، هادئة، ببيوت منخفضة وإضاءة خافتة. كنت قد سمعت كثيرًا عن انعدام الأمن في بوينس آيرس، لكن هذا المكان بدا آمنًا، مع حضور أمني ملحوظ.
شعرت أنني في أمريكا، نعم، لكن ليس تلك الأنجلوسكسونية التي نعرفها من السينما. هذه أمريكا أخرى، أمريكا أرييل، كما تخيّلها روبين داريو: قارة تتكلم الإسبانية، وتحلم، وتخطئ، وتغني.
عند الوصول إلى لا بوليتا، وبعد أن وضعتُ أمتعتي، عرض أوسوالدو—من باب الكرم—أن يدلّني على مكان قريب للعشاء. كانت الساعة التاسعة مساءً، وكان عليّ أن أستيقظ في الرابعة والنصف فجرًا لرحلة إلى إيغوازو.
توقفنا عند مخبز صغير تُحضّر فيه الإمبانادا. اشتريت اثنتي عشرة إمبانادا بعشرة آلاف بيزو، أقل من عشرة يورو. في الداخل، دار نقاش عفوي عن كوبا أمريكا وبطولة أوروبا. سألتني إحدى العاملات: من ستشجّع في نهائي الأرجنتين–كولومبيا؟ قلتُ ببساطة: «الأرجنتين». ضحكت، وقالت إنهم جميعًا سيشجّعون إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي اليورو.
الإمبانادا كانت استثنائية: عجين طري يذوب في الفم، نكهات صادقة، دجاج، لحم مقطّع بالسكين، بروفولون… طعام يشبه المكان: بسيط، عميق، غير متكلف.
أنا هنا لا لأنني أنتمي، بل لأنني اخترت. لا روابط دم، ولا لغة مكتملة، ولا ذاكرة عائلية. ومع ذلك، أشعر أنني في مكان أفهمه من الداخل.
الأرجنتين، بالنسبة لي، ليست وطنًا، بل مرآة: أرى فيها شغفي بالأدب، بالموسيقى، بالسفر بوصفه بحثًا عن الذات. وربما لهذا السبب بالذات، أستطيع أن أقول، دون تردّد: عاشت الهيسبانيداد… حتى لمن لم يولد فيها، لكنه أحبّها.
الفجر الذي يسبق المعنى
غادرتُ إيزيزا قبل أن يكتمل الضوء، وحيدًا كما ينبغي للرحلات التي تُقصد للفهم لا للمشاركة. في هذا الوقت المبكر، تصبح المطارات أماكن معلّقة بين الحلم واليقظة، ويغدو السفر شبيهًا باعتراف صامت: لماذا نمضي كل هذا البعد؟
كان سؤال المال أول ما شغلني. لطالما قال لي أرجنتينيون التقيتهم في باريس إن زيارة الأرجنتين تحتاج ما بين مئة ومئة وخمسين دولارًا يوميًا للفرد. كنت متشككًا حينها، وها أنا اليوم أكثر تشككًا. إن لم أحتج هذا المبلغ في أوروبا نفسها، فكيف أحتاجه هنا؟ لو كانت الأمور كما يقال، لما كانت اثنتا عشرة إمبانادا تُشترى بعشرة يوروهات، ولما كان كوب حليب في المطار—بسعر سياحي—يعادل أربعة يوروهات. قلت في نفسي: سنرى ما تقوله بويرتو إيغوازو.
استغرقت الرحلة الجوية بضع ساعات فقط. نمت خلالها نومًا خفيفًا، كأن الجسد يطالب بحقه قبل أن يطالب العقل بالتأمل. عند الوصول، استقبلني أدولفو، سائق التاكسي الذي سيصير، دون أن يدري، أحد وجوه هذه الرحلة.
حين تتقاطع السينما والتاريخ
قبل دخول بويرتو إيغوازو، مررنا بثكنة عسكرية. أشار إليها أدولفو قائلاً إن مشهدًا من فيلم The Mission صُوِّر هناك. سألتُه بفضول، فأخبرني أن معظم الفيلم صُوِّر في شلالات إيغوازو، وفي بعثة سان إغناسيو اليسوعية، على بعد مئتي كيلومتر تقريبًا.
كان لهذا الخبر وقع خاص عليّ. لم أكن أعلم أنني وصلت، دون تخطيط مسبق، إلى مقاطعة تحمل في ذاكرتها بعثة يسوعية قديمة. شعرت أن الصدفة هنا ليست عمياء، بل ذكية. قلت لنفسي: لا مجال للتردد، يجب أن أذهب إلى هناك.
اقترح أدولفو برنامج الإقامة:
- الخميس: مناجم واندا وبعثة سان إغناسيو – 130 دولارًا، رحلة يوم كامل.
- الجمعة: شلالات إيغوازو من الجانب البرازيلي – 30 دولارًا.
- الأحد: الشلالات من الجانب الأرجنتيني – 25 دولارًا.
- النقل إلى المطار – 15 دولارًا.
الدفع ممكن بالبيزو أو بالدولار. هنا، كما في كثير من الأرجنتين اليوم، العملة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل سؤال سياسي واقتصادي مفتوح.
الأرجنتين تعيش فوضى مالية دقيقة. الدولار هو العملة الحقيقية، المستقرة، فيما البيزو كائن متقلّب. هناك سعر رسمي، وهناك سعر الشارع.
في الشارع يظهر أشخاص يقفون كأنهم مزروعون في الرصيف، بأوراق خضراء تتدلى من أيديهم، أوراق الدولار. سعر الصرف هنا هو الدولار الأزرق. 850 بيزو رسميًا، 1450 بيزو في السوق الحرة. حتى اللغة، في الأرجنتين، تُبدع لتواكب الأزمة.
تركْتُ حقيبتي في الفندق، وخرجت لأتجول في مدينة يبلغ عدد سكانها تسعين ألف نسمة. بويرتو إيغوازو هادئة على نحو يثير الدهشة. لا جريمة، لا توتر. بيوت منخفضة، متواضعة، مساحات عائلية واسعة. سيارات عادية، بلا استعراض. شوارع تحتاج إلى عناية أفضل، لكنها صادقة.
الاقتصاد بوجه إنساني
دون هوب تاجر فريد. متجره يبيع إكسسوارات الهواتف، ويصرف المال. آلة عدّ النقود تعمل بسرعة مذهلة. حين دخلتُ، لم يكن أحد هناك. انتظرنا طويلاً قبل أن يخرج من الغرفة الخلفية مرتديًا بدلة رياضية، كان يلعب الريشة الطائرة مع صديقته.
قصير القامة، ملامحه ايطالية، ودود بلا تكلّف. اشتريت منه شريحة هاتف أرجنتينية بـ29 ألف بيزو، وصرفت 400 دولار بسعر 560 ألف بيزو. خرجتُ بست رزم نقدية، لا تتسع في الجيوب، فاضطررت لحملها في حقيبة الظهر. هنا، المال يُرى ويُحمل ويُحسّ بثقله.
اشتريتُ معطف مطر («piloto» كما يسمونه هنا) ومظلّة. البائعة تركتني وحدي في المتجر وخرجت. في مدينة غير آمنة، لا يفعل التاجر ذلك.
الغداء كان في مطعم دون ماتيو، كما أوصى أدولفو. ما يسمّى هنا بـ«الشوكة الحرة». مطعم نظيف، حديث، طاولتا بوفيه: واحدة نباتية، وأخرى للحوم واليخنات. 1100 بيزو لكل 100 غرام.
ملأتُ طبقي بسخاء: بطاطس مهروسة، فاصوليا، ميلانيزا، أضلاع مشوية، وكرة لحم ضخمة. دفعتُ حوالي 8500 بيزو، ومع ماء صحة، خرجت الفاتورة بنحو ستة يوروهات.
الزبائن، عمّال وعائلات من طبقات مختلفة. الطعام لذيذ، والمكان دافئ. هنا، المائدة مساحة مساواة مؤقتة.
عدتُ إلى الفندق مشيًا، قرابة عشرين دقيقة تحت مطر غزير. رأيت بيوتًا مهجورة، لكنها معتنى بها. كل شيء هنا منخفض: البيوت، الأصوات، التوقعات.
في المساء، ذهبتُ إلى دونا آنا—شوكة حرة أخرى. خيّبت أملي. طعام مُعاد تسخينه، أجواء أبرد، وسعر أعلى. ليس كل الكرم متساويًا.
ما شدّني في حديث أدولفو ودون هوب هو حلاوة اللهجة، عذوبتها، كجرس بعيد. أحيانًا يتركون الجملة غير مكتملة، كأن المعنى يُفهم بالإيحاء لا بالتصريح.
وأنا، المحب للثقافة الإسبانية دون إتقان لغتها، بدأت ألاحظ كيف تكشف الكلمات هويتك.
قولي «vale»، أو «claro»، أو استعمال بعض الأفعال، يكفي ليعرفوا أنك متطفل على اللغة الاسبانية. أما أدولفو، فكان يختم جُمَله دائمًا بـ: «No es cierto?» — أليس كذلك؟
كأن السؤال هنا ليس طلب تأكيد، بل دعوة خفيفة للمشاركة في الفكرة.
في بويرتو إيغوازو، تعلّمت أن الرحلة لا تُقاس بعدد المعالم، بل بقدرتها على زعزعة المسلّمات.
أنا مغربي، بلا روابط دم، بلا لغة مكتملة، لكنني هنا لأن التانغو علّمني أن الحنين يمكن أن يكون اختيارًا، ولأن تشي غيفارا أقنعني أن السفر—حين يكون صادقًا—هو شكل آخر من أشكال التفكير.
سفر في الجغرافيا وفي الفكرة
كان يوم الجمعة، الثاني عشر من يونيو، يومًا متردّد المزاج: غيوم تتناوب مع فسحات من صفاء خجول. موجة برد غريبة تزحف على هذه العروض الجغرافية، حيث يفترض أن يكون الشتاء لطيفًا، قريبًا من خمسٍ وعشرين درجة. لكن الحرارة هبطت إلى ما دون العشر، كأن الطبيعة نفسها قررت أن تذكّرنا بأن المفاجأة جزء من الرحلة.
في الثامنة صباحًا تمامًا، جاء أدولفو ليأخذني من الفندق. وحدي، كما ينبغي لمن يسافر بحثًا عن المعنى لا الصحبة. سرنا عبر الطريق 12 نحو أطلال بعثة سان إغناسيو، على بعد 244 كيلومترًا. مسافة طويلة على الخريطة، قصيرة في الإحساس.
الطريق عريض، جيد الصيانة، ذو مسارين فقط، لكن بكتفين واسعين من تربة طينية حمراء، تمتد خمسة أمتار على الجانبين. يشير أدولفو إلى لونها قائلاً إنها أرض شديدة الخصوبة. أحيانًا يظهر مسار إضافي للتجاوز، ما يسمّونه هنا «المسار الثالث»، كحل عملي لقانون يمنع التجاوز حيث لا معنى للمنع. وكما يحدث دائمًا حين لا تكون القواعد منطقية، تُكسر.
أدولفو يفعل ذلك أحيانًا، لكن قيادته حكيمة، هادئة، كحديثه. لا يتوقف عن الشرح، عن السؤال إن كنت أستمتع بما أراه. يخبرني أن الطريق لم يتجاوز عمره عشرين عامًا.
نعبر غابة شاسعة، ليست كثيفة خانقة، بل غابة فُتحت فيها فسحة هائلة لشريط إسفلتي يشقّها كلسان أسود لا ينتهي. خطوط مستقيمة تمتد لعشرات الكيلومترات.
على الجانبين، هكتارات لا تُحصى مملوكة لشركة واحدة: «أراوكو»، عملاق تشيلي يعمل في قطع الأخشاب في إحدى عشرة دولة.
أسأل نفسي: كم تساوي هذه الغابات؟ أي ثروة هذه التي تنمو ثم تُقطع ثم تُزرع من جديد؟
شاحنات محمّلة بالأخشاب تمر بلا توقف. مناطق قُطعت حديثًا وأخرى أُعيد تشجيرها، كأن الطبيعة هنا تدخل في دورة صناعية. بسخرية خفيفة، أتذكر لا أراوكانا لألونسو دي إرسيلا، وأتأمل كيف تعود النصوص القديمة لتطلّ من قلب المشهد الحديث.
حين تلتقي الأرض بالأسطورة
تظهر قرى صغيرة على جانبي الطريق: مساكن عمال، وقرى للغواراني (الشعوب الأصلية). الأرض مسطّحة، شبه لا نهائية.
الأبعاد المغربية أو الأوروبية التي تعوّدناها تتلاشى هنا. أمريكا تُربك الإحساس بالحجم: كل شيء أكبر، أوسع، أكثر جرأة.
نتوقف في مناجم واندا، موقع سياحي اكتشفه ألماني صدفة قبل خمسين عامًا. البازلت، الأميثيست، الكوارتز، التوباز… جولة إرشادية لا تتجاوز 5000 بيزو.
المرشد ودود، يشرح تكوّن الأحجار، ويشرح أيضًا سبب اللون الأحمر للأرض: الأكسدة.
رأيت مثل هذه الأحجار في الأطلس المغربي، وأقول ذلك في سري، فأبتسم لهذا التقاطع البعيد بين الجغرافيا.
الغريب أن الشرح لا يكتفي بالعلم، بل يربط كل حجر بقوة خفية: حجر للحب، حجر للصداقة، حجر للطاقة.
أسأله عن حرب قديمة بين الأوروغواي والبرازيل والأرجنتين. لا يعرف السبب، لكنه يعرف النتيجة: «الأرجنتين فازت»، يقول مبتسمًا.
أسأله لماذا ليست الأوروغواي وباراغواي والأرجنتين بلدًا واحدًا. يفاجَأ. لا جواب.
في النهاية، ندخل ما يسمّى «صالة كبار الشخصيات»، حيث تُعرض المجوهرات الأغلى مع قصص عن قواها السحرية. ثم غرفة أخرى للأحجار الخام. اشتريت حجرين تذكاريين بثمن متواضع وغادرت.
عند الخروج، أطفال من الغواراني يضعون حجارة صغيرة على الطريق ليجبروا السيارات على التوقف. يبيعون أحجارًا مثلهم. المشهد يعيدني فورًا إلى الأطلس، حيث كان الأطفال يفعلون الشيء نفسه لكن بدون أحجار تعيق الطريق. الفقر يتشابه أينما كان.
تفاح على الإسفلت ومطعم قبل الأطلال
نواصل الطريق. أكشاك بدائية على الجانبين يبيع فيها الغواراني أوركيد وحِرفًا بسيطة. فقر واضح، أكواخ بلا أسقف أحيانًا، أربع نبتات، كيسان معلّقان. خلفها، قراهم الصامتة.
فجأة، ازدحام. أطفال يركضون على الأكتاف العريضة للطريق. دراجات نارية وهوائية. نرى تفاحًا… في كل مكان.
شاحنة انقلبت واحترقت مقصورتها، وحمولتها من التفاح صارت غنيمة عامة. الشرطة أغلقت مسارًا، والناس تجمعوا. أطفال، عائلات، أكياس ضخمة تُحمل على الأكتاف. الخبر انتشر شفهيًا، فجاء الناس من القرى المجاورة، ثم عادوا محمّلين. المشهد مضحك ومؤلم في آن. الفقر هنا لا يختبئ.
نصل أخيرًا إلى أطلال سان إغناسيو، قبل الدخول، أتوقف في مطعم بسيط، ربما الأشد فقرًا الذي رأيته هنا. لكنه يجذبني لأن صاحبته من السلفادور، وتقدّم طعامًا سلفادوريًا لم أذقه من قبل.
أربع طاولات غير متشابهة، ومدفأة صغيرة تمنح المكان دفئًا بدائيًا. الزبائن جميعهم يبدون كمغامرين عابرين.
الحساب نحو 30 ألف بيزو (21 دولارًا). الخدمة بطيئة جدًا. يخبرني النادل—وهو ابن الطاهية—أنهم ذهبوا ليجلبوا الطحين لأحد الأطباق. ذهلت. فطلبت إلغاء الطبق. تخرج الطاهية معتذرة بخجل شديد.
الطعام بلا ملح. يقدّمون الملح لاحقًا. تجربة لن أكررها. لكن الناس طيبون، بسطاء. تركت بقشيشًا كريمًا وأغادر.
أطلال سان إغناسيو: الزمن متحجّرًا
لا أحد عند المدخل ليبيع التذاكر. أدخل بلا عائق. وفجأة… عالم آخر. كنيسة مهدّمة، هائلة، مبنية من حجر بلون الطين الصدئ، هو نفسه الذي يغطي كل شيء هنا، ويصنع تباينًا صارخًا مع الخضرة.
الدير أوسع من بلازا مايور في مدريد. الساحات، الإسطبلات، الأروقة… كلها خراب، لكنها تنطق بعظمة ماضية.
أحاول أن أتخيل القرنين السادس عشر والسابع عشر. ليس سهلًا، لكن الحجم وحده يكفي ليفرض الاحترام.
أتذكّر The Mission، وأتذكّر تشي غيفارا، وأدرك أن أمريكا اللاتينية تُنتج دائمًا شخصيات تمشي بين الإيمان والتمرّد.
نعود عند الغروب. أفكار ثقيلة ترافقني. رأيتُ عظمة إمبراطورية وانهيارها. رأيتُ ثروة طبيعية لا نهائية، وفقرًا لا يُنكر. وعلى الطريق، الغواراني أنفسهم، لكن الشاحنة فارغة الآن. لا تفاح.
أتذكر قول مارسيلو غولو: «نحن غير متطوّرين لأننا منقسمون، ولسنا منقسمين لأننا غير متطوّرين.»
يحلّ الظلام. نصل بويرتو إيغوازو متأخرين. خمسمئة كيلومتر. تعب صامت. لا رغبة في الخروج. أتناول إمبانادا بسيطة في الفندق.
صباحٌ لا يصلح إلا للتأمّل
استيقظت يوم السبت، الثالث عشر من يونيو، على وجهٍ قاسٍ: أمطار غزيرة، رياح عاتية، وبرودة قاربت الصفر. يومٌ من تلك الأيام التي يُستحب أن تُشاهَد من خلف الزجاج، وأنت ملفوف بالدفء، تتأمل كيف تنفتح السماء دفعة واحدة لتغسل الأرض.
لكن السفر لا يعترف براحة التأمل، ولا يؤجل مواعيده من أجل الطقس. لم يكن هناك يوم آخر مخصص لزيارة الجانب البرازيلي من شلالات إيغوازو، فلبست معطف المطر، حملت مظلتي الرقيقة، ونزلت لملاقاة أدولفو، الذي كان – كعادته – ينتظر عند باب الفندق بإخلاص يشبه المريد.
في الطريق، يحدثني أدولفو عن حياته كما لو كان يقدّم بيانًا وجوديًا مختصرًا: يأكل قليلًا، لا يتعشّى أبدًا، ويكتفي بـ ماتيشيتو خاص به، يشير إليه كل مرة باعتزاز، كأنه دواء شامل: يهدّئ، يغذّي، يساعد على الهضم والنوم… «فيه كل شيء»، يقولها وهو يبتسم ابتسامة رجل وجد توازنه.
ينطق الإسبانية بنبرة موسيقية لطيفة، وعندما يصف لحظة عودته إلى البيت ليسترخي ويشرب مشروبه، يبدو أسعد رجل في العالم. بساطته ليست فقرًا، بل اختيارًا.
أتذكر ما قاله لنا دليل المناجم بالأمس: راتب المعلم هنا لا يتجاوز 220 ألف بيزو شهريًا، أي ما يعادل 150 دولارًا تقريبًا. أفهم أدولفو أكثر. خلال أربعة أيام، سيجني من رحلاتي معه ما يعادل دخل شهر كامل، لذا يحرص عليّ كما لو كنت مشروعًا صغيرًا للأمان.
الحدود: عبور اللغة والهوية
يشرح لي إجراءات العبور إلى البرازيل، ويسردها ببرتغالية طريفة ذات نطق برازيلي يكاد يكون مسرحيًا. يسألني إن كنت أفهم، فأهز رأسي. في الحقيقة، لا أتقن الإسبانية أصلًا، فكيف بالبرتغالية؟ لكن في السفر، الفهم لا يكون بالكلمات فقط.
نصل إلى الحدود. إجراءات سريعة. ختمٌ على جواز السفر. ها أنا في البرازيل. دولة جديدة، لغة جديدة، والمطر لا يزال ينهمر وكأنه جزء من المشهد الرسمي.
يوصلني أدولفو إلى مدخل الحديقة. المطر يشتد، فيعطيني مظلة أفضل من مظلتي، أقبلها ممتنًا.
كل شيء هنا منظم بدقة: التذاكر، العربات ذات الطابقين التي تنقل الزوار إلى مسار الشلالات، الطوابير، الإشارات.
أصعد إلى الطابق العلوي رغم المطر. معظم الركاب برازيليون. يضحكون بصوت عالٍ، يتحدثون معًا وكأنهم عائلة واحدة. لم أرَ بشرًا أكثر صخبًا وسعادة منهم.
أفكر، بابتسامة خفية، أن هذا البلد جنة لمن يعاني ضعف السمع… وجحيم لمن يسمع جيدًا.
لكن فجأة، يتغير كل شيء. الماء يتسلل إلى الحافلة، والريح الباردة تصفع الوجوه. يخفت الضجيج فجأة، كأن هدفين سُجّلا في مرمى الفرح. ألوذ بالدرج عند المخرج، أبحث عن مأوى صغير من الريح.
الشلال: حيث يصبح الخلق مرئيًا
بعد عشرين دقيقة تقريبًا، أصل إلى الشلالات. المشهد الأول صاعق. الماء يأتي من كل الجهات، كأن السماء فتحت أبوابها دفعة واحدة. عشرات الشلالات تهوي من ارتفاع أربعين أو خمسين مترًا، خارجة من قلب الغابة. نهر إيغوازو هنا عريض، متشعّب، يتحوّل إلى مدرج مائي هائل يمتد لمئات الأمتار.
الماء بنيّ اللون قبل السقوط، ثم يتحول إلى بياض كثيف، إلى رغوة وضباب يبتلع المشهد أحيانًا.
الأمطار تزيد الطين بلّة… والمشهد بلاغة. لم أرَ في حياتي طبيعة أكثر حياة من هذه. أتمتم، مستعيرًا عبارة قديمة: «هنا أرى عظمة خلق الله». ليس تعبيرًا مجازيًا. هنا الخلق مكتوب بحروف كبيرة.
وأتذكر The Mission، وأتذكر الموسيقى، وأتذكر تشي غيفارا، ذلك الوجه الذي كان يبحث عن معنى للعدالة في قارة لا تكف عن إنجاب الأسئلة.
أسير على ممر خرساني بمحاذاة الجرف، أطل منه على الشلالات من الجانب الأرجنتيني. الفيضان جعل المياه أعنف من المعتاد، ولهذا أُغلق الوصول إلى «حنجرة الشيطان» من الجانب الآخر.
الريح قوية، والمطر لا يرحم. أبتل تمامًا. المظلة لا تصمد طويلًا… تنكسر. أواصل التقدّم حتى أقرب نقطة ممكنة، ثم أستسلم. لا حاجة للمكابرة أمام هذا الجنون الجميل.
رحلات القوارب المطاطية أُلغيت. خسارة صغيرة أمام ما رأيت.
أدخل متجر الهدايا، أشتري ملابس جافة وأحذية خفيفة. أخرج مبللًا… لكن ممتلئًا.
كان من المفترض أن أتناول شواءً برازيليًا في مطعم موصى به، لكن البلل والإرهاق يفرضان قرارًا آخر. أقرر زيارة حديقة الطيور.
لم تكن الطيور يومًا شغفي، لكن الغابة… الغابة دائمًا تفعل. الممر الخرساني الضيق يدخل بي إلى قلب الغابة. طيور من كل أنحاء العالم، بعضها يمر بقربي، بعضها في أقفاص هائلة تذوب في الخضرة.
أتخيل الأب غابرييل، أولئك المبشرين قبل أربعة قرون، يشقّون هذه الغابات دون خرائط، محاطين بالخوف، بالجوع، بأصوات الطيور والحيوانات.
أي شجاعة هذه؟ وأي جنون جميل؟ أدرك أن دخولي هنا لم يكن عبثًا. بعض الأمكنة لا تُزار مرتين.
ينتظرني أدولفو عند المخرج. السيارة دافئة. أشتري له مظلة جديدة بدل التي انكسرت، من متجر رخيص يبيع كل شيء… نسخة فقيرة من العالم.
نعبر الحدود عائدين إلى الأرجنتين. الوقت تأخر، لا غداء ولا عشاء حقيقي. أعود إلى الفندق، أدفئ جسدي، وأكتفي بإمبانادا بسيطة.
سؤال أخير قبل النوم، كان يومًا لا يُنسى. رأيت جمالًا لا يمكن للعقل أن يختزله في الصدفة.
هل يمكن لكل هذه العظمة أن تكون عبثًا؟ لا يمكن ذلك.
حين يعود المسافر مختلفًا
هكذا تنتهي هذه المرحلة من الرحلة، لا بانطفاء الدهشة، بل بتكثّفها. فالأرجنتين لم تكن مكانًا يُزار ثم يُغادر، بل تجربة تُعيد ترتيب الداخل، وتضع المسافر أمام أسئلته العارية. بين الإمبانادا البسيطة وشلالات إيغوازو المهيبة، بين لهجةٍ لا أُتقنها وأفهمها بالقلب، وبين تاريخٍ ينهض من الخراب كما تنهض الأطلال من الطين الأحمر، تعلّمت أن السفر ليس حركة في الجغرافيا، بل ارتباكٌ ضروري في المعنى.
كنتُ وحيدًا، لكنني لم أكن معزولًا. كانت الموسيقى، والكتب، والوجوه العابرة، والسياسة، والفقر، والطبيعة، كلها رفقةً غير معلنة. أدركت أن الانتماء لا يُمنح بالدم، بل يُكتسب بالإنصات، وأن الهويّة ليست ما نحمله معنا، بل ما نسمح له بأن يهزّنا.
هذه اليوميات لا تدّعي الاكتمال، ولا تبحث عن خلاصٍ نهائي. هي مجرد أثر أقدام على طريق طويل، وتحية صامتة لأمكنةٍ علّمتني أن العالم أوسع من خرائطه، وأن السؤال—حين يُسافر—يصبح أكثر صدقًا من الجواب.
سأغادر الأرجنتين، نعم، لكن شيئًا منها سيغادر معي: نبرة في الصوت، صورة ماءٍ يهوي من السماء، وإيمان خافت بأن الجمال، حين يُرى حقًا، لا يترك صاحبه كما كان.